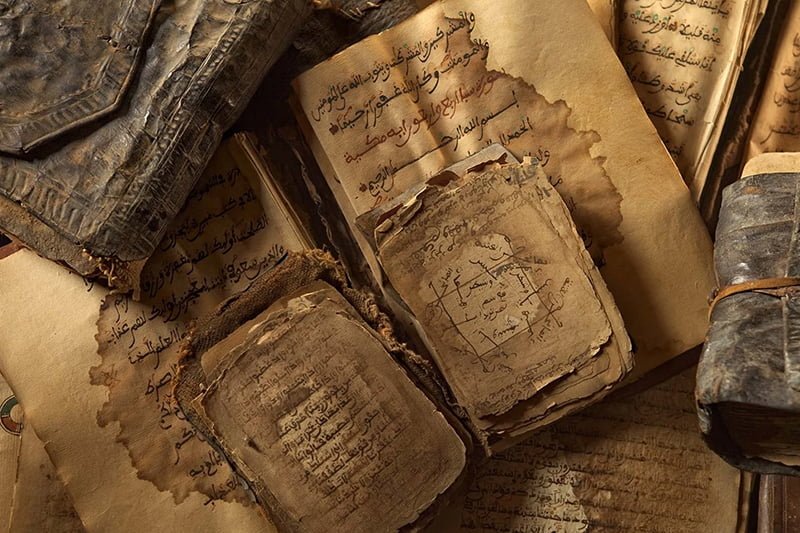تعود معظم الانتهاكات التي صدرت عن المستشرقين إلى خلفيتهم ومنطلقاتهم من جهة، وإلى منهجهم الذي يعتمدونه لخدمة أغراضهم من جهة ثانية، وحسب تقديري فإن الإطلاع على هذه المناهج والتعرض لأهم الاختلالات التي تعاني منها أمر من الأهمية بما كان، نظرا لما تزود به القارئ من قدرة على النقد والضحد والرد على كل تلك الترهات مهما تعددت وتشعبت.
فما هي مناهج المستشرقين؟ وما مصادرها؟ وما أنواعها؟
- مقومات المنهج الاستشراقي:
استمد المنهج الاستشراقي مقوماته من المناهج الغربية المرتكزة على أسس مغايرة لروح السيرة النبوية وواقائعها.[1]
فقد اعتبر هذا المنهج أن السيرة النبوية مسألة تاريخية صرفة تخضع -كغيرها من الوقائع التاريخية- لأساليب النقد والتحليل السائدة في الدراسات التاريخية، ثم إنها تبنت مبدأ التشكيك في السيرة النبوية ككل وفي السنة النبوية المطهرة على وجه الخصوص، وهذا له ارتباط بما عرفه الفكر الأوربي من سيطرة الشك الديكارتي على مناهجه حيث شكل قاعدة صلبة للمستشرقين في تناولهم للأحداث والوقائع التاريخية عامة والمتعلقة بالسيرة النبوية وتاريخ الإسلام خاصة.
كما أن أصحاب هذه المناهج لم يعرفوا للموضوعية -التي يزعمون نهجها- طريقا، فهم لا يقبلون على دراسة السيرة النبوية إلا مستحضرين لخلفيتهم الدينية المنبثقة من المركزية المسيحية والاهوت المسيحي…
- أهم مناهج المستشرقين في دراسة السيرة المطهرة.
اتبع المستشرقون مناهج عديدة في كتابة السيرة النبوية، وتشترك كل هذه المناهج في كونها مناهج لا تأخذ السيرة النبوية كأمر تاريخي له خصوصياته وله ملابساته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء الدراسة والتحليل، ولكن هذا الأمر نجده دائم الغياب في كتابات ودراسات المستشرقين، لذلك سنحاول –قدر الإمكان-أن نتعرف على أهم تلك المناهج ولو بشكل موجز وبسيط.
- منهج الأثر والتأثر:
وهو منهج اتبعه غالبية المستشرقين حيث تم إفراغ افسلام من ذاتيته، وذلك بإحالتها إلى مصادر خارجية هي النصرانية واليهودية والبابلية والمجوسية، حيث تم الاشتباه في الاسلام وتشريعاته ومدى تأثره بالأديان السابقة.
فعلى سبيل المثال يرى المستشرق وانتجمري وات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بأفكار ورقة بن نوفل المسيحي. بل إن افكار ورقة أثرت في التطورات الإسلامية اللاحقة. وبهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإنه أخذ ينقل عن اليهودية والمسيحية لصياغة ديانة جديدة هي الإسلام.
ويذهب بروكلمان إلى ابعد من ذلك فيضيف إلى اليهودية والمسيحية الآرامية والفارسية والبابلية…
وهذه النظرة لا تخرج عن اعتقاد أن الإسلام هو مجرد تلفيقات يهودية ومسيحية وغيرهما… وبالتالي فهي تنفي الذاتية عن الإسلام وتحيلها إلى غيره من الديانات والمعتقدات وبالتالي تجريد محمد صلى الله عليه وسلم من نبوته.
- المنهج العلماني:
وهو منهج يسبعد وقوع ظواهر دينية لا تخضع لقوانين الأجسام المادية المعروفة، بمعنى آخر فإن هذا المنهج ينبني أولا وأخيرا على نفي المعجزات والخوارق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم.
فبروكلمان ينظر إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نظرة عادية مجردة من بعدها الديني حيث يعتبر أن فكرة النبوة نضجت في نفس محمد صلى الله عليه وسلم فاعتقد أنه مدعو لأداء رسالة النبوة… كما يفسر واقعة الإسراء والمعراج بكونها لا تعدوا أن تكون رؤى في اثناء تهجد العراف وهي أمور ثابتة معروفة لدى بعض الشعوب البدائية.
- المنهج المادي:
مع نجاح الثورة الشيوعية في روسيا ظهر المنهج المادي الذي يجعل للعامل الاقتصادي أهمية قصوى في تفسير الواقعة التاريخية.
فيعزو وات مثلا سبب ظهور الإسلام إلى التطور الذي عرفته جزيرة العرب حيث انتقل العرب من حياة بدوية إلى اقتصاد حضري، ويذكر أن التوتر الذي كان يشعر به محمد وبعض معاصريه يعزى في النهاية إلى ألساس الاقتصادي.
وتتوالي هذه التفسيرات المادية للأحداث السيرة تترى حيث تفسر الفتوحات بكونها تخضع للعامل الاقتصادي حيث السطوة على الغنائم أكثر مما تخضع لمبدئ عقدي هو الجهاد في سبيل الله.
وهكذا فإن كثيرا من المناهج المستخدمة في دراسة السيرة من لدن المستشرقين إنما تنحوا في الغالب العام هذا المنحى التشكيكي النابع من دوافع عدائية للإسلام.
- معالم الفهم الجاد للسيرة النبوية.
لم يكن هدفي من استعراض هذه الاختلالات هو الجمع والوصف بقدر ما كان هدفي هو التنبيه عن بعض منها إضافة إلى طرح بعض من الركائز الأساسية التي ينبغي اعتمادها أثمناء مقاربة مواضيع السيرة النبوية.
- الأساس الاعتقادي:
لا يمكن بأي حال من الأحوال دراسة أي موضوع أو قضية بمعزل عن أصولها التي تستمد مقوماتها منها، وكذلك الأمر بالنسبة للسيرة فلا يمكن دراستها بمعزل عن الإيمان، وبما أن الأمر متعذر عن دارس لا يدين بدين الإسلام، فهنا يجب حضور ولو على اقل تقدير احترام للمصدر الغيبي الذي تنبني عليه السيرة، وإلا فالأولى تناوله بالدراسة الموضوعية قبل دراسة السيرة.
- الموضوعية:
غالبا ما يركز المستشرقون على الموضوعية وضرورة نهجها في الأبحاث والممارسات العلمية، لكن أية قراءة ولو بسيطة لنتاجهم الفكري نجده ابعد ما يكون عن هذه الموضوعية، لذلك لا يمكن أن تكون هذه الدراسات على قدر كبير من الصحة إلا إذا توفرت على الموضوعية وابتعدت عن الذاتية.
- الإحاطة بأدوات البحث التاريخي:
وإن كان هذا الأمر حاضرا لدى كثير من المستشرقين إلى أن توظيفه أثناء دراسة السيرة غنما يكون بشكل موجه يخدم الأحكام المسبقة والجاهزة والنظرة الاختزالية لمواضيع السيرة النبوية المطهرية.
[1] د.الأمين النعيم، عبد الله: الإستشراق في السيرة النبوية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الكبعة الأولى، 1998م، ص 33.