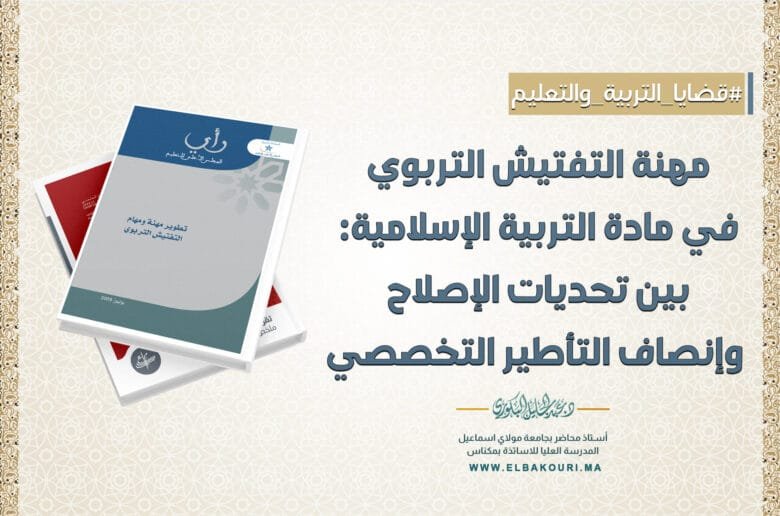مقدمة:
يُعد تطوير مهنة التفتيش التربوي من الرَّافعات الأساسيَّة لأي مشروعٍ إصلاحيٍّ يهدف إلىٰ تجويد المنظومة التَّربويَّة وتحسين مردوديَّتها. إذ تُمثِّل أداةً وظيفيةً لمواكبة الأطر التَّربويَّة، وتوجيه الممارسات الصَّفية، وضمان التَّقويم المستمر للعمليات التَّعليميَّة والتَّعلُّمية. وقد أكَّدت مختلف الأدبيات التَّربويَّة المُعاصرة علىٰ الدَّور المحوري للتَّفتيش في دعم التَّطوير الإيجابي لمهمَّة التَّدريس، من خلال التَّحوُّل من مَنطق المُراقبة إلىٰ منطق التَّأطير والمُصاحَبة المهنية.
ورغم ما راكمه المغرب من أوراق استراتيجية، وفي مقدمتها الوثيقة المُعبِّرة عن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2009 في موضوع التَّفتيش بعنوان “تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي”، لا يزال واقع التَّفتيش التربوي في المنظومة الوطنية يكرّس مفارقة حادَّةً بين وظيفة التفتيش كما تُراد، وواقع التَّفتيش كما يُمارس. إذ يعاني هذا الجهاز من إشكالات متعدِّدة، من بينها علىٰ سبيل المثال: محدوديَّة التَّكوين المستمر، وتعدُّد التَّكليفات، وغموض الأدوار، وضعف استقلالية القرار التَّربوي للمُفتِّش، ناهيك عن تفاوت التَّغطية المجالية والاختصاصيَّة.
وقد أعادت مباراة ولوج مركز تكوين مفتِّشي التَّعليم برسم سنة 2025 طرح هذا الوضع إلىٰ الواجهة، خصوصًا بعد الإعلان عن عددٍ محدودٍ من المناصب مقارنة بالحاجيات الفعليَّة للمنظومة، هذا مع غياب تخصُّص التَّربية الإسلاميَّة ضمن التَّخصصات المطلوبة. الأمر الذي يدعو إلىٰ التَّساؤل حول مدىٰ حضور هذا التَّخصُّص في أولويات السِّياسات التَّأطيرية للوزارة، رغم مكانَة هذه المادَّة التربوية ودورها في ترسيخ القيم داخل المدرسة المغربية.
انطلاقًا من هذا السياق؛ سنعىٰ في هذا المقال إلىٰ إثراء النِّقاش في هذا الموضوع من خلال:
- إعادة تسليط الضوء علىٰ بعض الإشكاليات التي يعرفها واقع مهنة التَّفتيش التربوي بالمغرب.
- تحليل محاور وثيقة المجلس الأعلىٰ حول تطوير مهام التَّفتيش.
- إبراز ملامح التَّصور الاستراتيجّي لمهنة التَّفتيش كما تقدمه الرُّؤية الاستراتيجية 2015–2030.
- عرض أهم ما تقترحه الأدبيات التَّربويَّة الدَّولية الحديثة بشأن مِهنة المفتش.
- تسليط الضَّوء علىٰ وضعية مفتشي التربية الإسلامية في هذا السياق.
ونأمل أن تُسهم هذه المقالة في تجديد النِّقاش حول وظيفة التفتيش وتسديده، وكذا اقتراح مداخل ممكنة لبناء تصور مهنيٍّ مُتجدِّدٍ للتَّفتيش التَّربويِّ.
إشكالات مهنة التفتيش التربوي بالمغرب: لمحة موجزة.
يعاني التفتيش التربوي في المغرب من اختلالاتٍ بنيويَّة ووظيفيَّة تُقلّص أثارَه المرجوَّة في تجويد العمليَّة التَّعليميَّة، كما تُضعف قُدرتَه علىٰ مواكبة مشاريع الإصلاح. وقد رصدت وثيقة “تطوير مهنة ومهام التَّفتيش التَّربوي” الصَّادرة عن المجلس الأعلىٰ للتَّربية والتَّكوين (2009) جملةً من تلكم الإشكالات، التي ما تزال قائمة إلىٰ اليوم، منها:
غموض المهام وتشتّت الأدوار
تُشير الوثيقة إلىٰ أنَّ مهنة التَّفتيش تعاني من “غياب تحديدٍ دقيقٍ لمجالات التَّدخل ومجموعة المهام، وضُعف آليات التَّنسيق علىٰ الصَّعيدين الأفقيِّ والعموديِّ، ممَّا يؤدي إلىٰ تشتّت الأدوار والتَّكليفات وتداخلها بين البيداغوجيِّ والإداريِّ.
ولا يخفىٰ أنَّ هذا الغموض يؤثِّر سلبًا علىٰ فعالية التفتيش ويُربك الأدوار التَّكوينية والتَّقويمية للمفتش التربوي.
محدوديّة التَّكوين الأساسيّ والمستمر
تسجّل الوثيقة أيضًا توقف التكوين الأساسي بالمركز لما يقرب من عقد كامل (1999–2009)، باستثناء مسلك الإدارة التربوية، وتُبرز أنَّ التَّكوين حين يُتاح، يغلب عليه البعد النظري، وتغيب عنه المقاربات التَّكوينية الحديثة ذات البُعد التطبيقيّ والعمليّ.
أما التكوين المستمر، فتصفه الوثيقة بأنه غير منتظم، يفتقر إلىٰ التخطيط، وتغيب عنه آليات المواكبة والتَّقويم.
ضعف الاستقلالية التَّربويَّة للمفتش
تنتقد الوثيقة بشكلٍ صريحٍ غياب إطارٍ تنظيميٍّ يضمن للمفتِّش استقلاليَّةً وظيفيَّة، حيث يُعاني من التَّبعيَّة الإدارية التي تُضعف موقعه المهني.
وتدعو الوثيقة إلىٰ وضع تصوُّرٍ جديدٍ يُمَكّن المفتِّش من الاشتغال داخل “منطقٍ تعاقُديٍّ”، يضمن المُساءلة كما يكفل في الآن ذاته الاستقلال التَّربوي الضَّروري لأداء دوره.
اختلالات التَّغطية المجالية والتَّخصُّصية
وتشير الوثيقة إلىٰ وجود فوارق كبيرة في نِسب التَّأطير بين الجِهات، وبين الأسلاك التَّعليميَّة، والتَّخصُّصات، وفي هذا السياق تُسجّل خَصاصًا ملحوظًا في بعض المواد الدِّراسيَّة، لا نستبعد أن تكون مادة التَّربية الإسلاميَّة أبرزها. وتربط الوثيقة هذا الخصاص بضعف الخريطة الوطنية للتَّأطير، وتوصي بإرساء تخطيط استراتيجي لتوزيع المفتشين على ضوء الحاجات الفعلية.
ضعف الأثر التَّقويمي والوظيفيّ
تسجّل الوثيقة أنَّ التَّقارير التَّربويَّة التي يُنجزها المفتِّشون لا يتمُّ استثمارها بشكل مؤسساتي، ما يجعل أثر التفتيش في تدبير القرار التَّربوي محدودًا.
ويُضاف إلىٰ ذلك غياب معايير واضحة لتقويم المفتشين أنفسهم، ممَّا يُضعِف منطق المحاسبة المهنية والتَّطوير المستمر
خلاصة لما سبق ذكره؛ وبمقارنة مع الوضع الحالي لمهنة التَّفتيش، يتبيّن أنَّ وظيفة التَّفتيش، كما تُمارَس اليوم، لا تزال بعيدةً عن التَّصور المهني الفاعل الذي يُمكّنها من المساهمة الفعلية في تجويد التَّعليم.
التصور الاستراتيجي لمهنة التفتيش التربوي رؤية تحليلية وتركيبية
تشترك الرُّؤية الاستراتيجية 2015–2030 ووثيقة المجلس الأعلىٰ للتربية والتكوين لسنة 2009 المُعَنوَنة بـ”تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي” في بناء تصوّر جديدٍ لمهنة التفتيش، يقوم علىٰ قناعة مركزيَّةٍ مفادها أنَّ الارتقاءَ بالمدرسة المغربية يحتاج -مِن بين ما يحتاجه- إلىٰ إصلاحٍ جذريٍّ وشاملٍ لوظيفة التَّفتيش.
فكلا الوثيقتين تضعان علىٰ عاتق المُفتِّش رهاناتٍ نوعيةً، وتُعيدان رسم ملامحه كمؤثِّرٍ تربويٍّ رئيسيٍّ، لا كمجرد ملاحِظٍ خارجيٍّ أو موظَّفٍ إداريٍّ تقنيٍّ، وفيما يلي تحليلٌ وتركيبٌ لأهم مقتضيات الوثيقتن:
من المراقبة إلىٰ المصاحبة المهنية
ينطلق التَّصوُّر الجديد من تجاوز المقاربة التَّقليدية التي اختزلت مهامَّ المفتش في المراقبة وضبط الأداء، إلىٰ رؤية تجعل من التَّفتيش ممارسةً تأطيريَّةً مصاحِبة، تضع تحسين الممارسة الصَّفية غايةَ الغايات.
وفي هذا السياق، يظهر المفتش بوصفه موجهًا ومكوِّنًا ومقيمًا داخليًا، يُسهم في تجويد أداء المدرّسين، ويواكب المؤسَّسات في تفعيل مشاريعها، ويقدّم تغذيةً راجعةً بنّاءة بدل التقييم الأُحادي.
ضبط المهام ضمن إطار مرجعيٍّ للكفايات
تسعى الوثيقتان إلىٰ تحرير مهنة التفتيش التربوي من التَّداخلات والتَّكليفات العَرَضية، عبر بناء مرجعية واضحة للكفايات المهنية، تُحدِّد المهامَّ والوظائف، وتُتيح تقويم الأداء ومساءلته.
فالحديث عن التفتيش التربوي باعتباره “مهنة” لا يستقيم دون تحديد وظائفها وحدودها، وربطها بنظام تكوينيٍّ وتأهيليٍّ متكامل. وهذا ما نادت به وثيقة 2009 من خلال مقترح إطار مرجعي وطني قابل للتَّنزيل.
مهنة التفتيش في صلب الحكامة التَّربويَّة
لا يُنظر إلىٰ المفتش في هذا التصور باعتباره عنصرًا إداريًّا يتدخَّل من الخارج، بل فاعلًا ميدانيًا في قلب المنظومة، يُشارك في القيادة التَّربويَّة، ويؤطّر السِّياسات التَّعليميَّة علىٰ المستوىٰ المحلِّي والجِهوي.
فموقع المفتش، في هذا الإطار، لا يقلّ أهميَّة عن المدير أو رئيس المؤسسة، بل يُفترض أن يكون صلة وصل بين الرؤية الإصلاحية وبين التَّفعيل اليومي للبرامج والمناهج.
تكوين مستمر وممهنن
تُلقي الوثيقتان الضَّوء علىٰ الحاجة الماسّة إلىٰ تجديد مسارات التَّكوين الأساسيّ، وجعل التكوين المستمر مشروعًا مهنيًا دائمًا مرتبطًا بالحاجات الواقعية للمفتش. إذ لا إصلاح بدون مفتش متمكن من أدوات التَّشخيص، واعٍ بتحوُّلات المناهج، قادرٍ علىٰ التَّوجيه والاقتراح والمرافعة التربوية. ولهذا، يُعَدُّ التكوين – في التَّصوُّر الجديد – مسؤوليَّة مؤسَّساتية لا فردية.
ضمان عدالة تأطيرية ومجالية وتخصصية
يرتبط تفكيك الفوارق التعليمية بمجموعة من الشروط، أبرزها ضمان تغطية تأطيرية عادلة لجميع المؤسَّسات والتَّخصصات. وتشير الوثيقتان إلى وجود اختلالات حادة في هذا الجانب، خاصة في بعض المواد –نعود ونقول لعلَّ التربية الإسلامية من أكثر المواد تضررا– والمناطق القروية. لذا، فإنَّ إنصافًا تأطيريًّا حقيقيًّا يقتضي تخطيطًا وطنيًّا عادلاً لتوزيع الموارد التَّأطيرية، بعيدًا عن منطق العرض الإداري الجامد.
بعد هذا العرض -علىٰ طابه الاختزالي- يمكن أن نخلص إلىٰ أنَّ التصور الذي تبنيه الرُّؤية الاستراتيجية ووثيقة تطوير مهنة التفتيش التربوي يطمحُ إلىٰ تحقيق نقلة نوعية في فهم وظيفة التفتيش، إذ لم يعد الأمر يتعلَّق بتعديلاتٍ إجرائيَّة، بل بإعادة بناء شاملة لهُويَّة مهنية كاملة. فالوثيقتان، وإن اختلفتا في الأسلوب –بين النَّفَس الاستراتيجي، والطابع التشخيصي الإجرائي– إلَّا أنهما تتكاملان في الإقرار بأن التَّفتيش يُعتبر إحدىٰ بوابات إصلاح التَّعليم.
لكن؛ علىٰ الرغم من وضوح هذا التَّصور وتكامله النَّظري، فإنَّ تنزيلَه الميداني يواجه تحديَّاتٍ واقعية، من بينها: غياب الإرادة المؤسَّساتية الكاملة، استمرار منطق المراقبة في الممارسة اليومية، ضعف التَّكوين، والتَّهميش الذي يطال بعض التَّخصُّصات الحساسة، من بينها مادة التربية الإسلامية.
ويبقىٰ القول: إنّ تحويل هذا التصور من وثيقة مؤطِّرة إلى ممارسة حيّة، هو أحد أهم تحديات الإصلاح التَّربوي الرَّاهن.
مهنة التفتيش التربوي في الأدبيّات التربوية المعاصرة: نحو وظيفةٍ تربويّةٍ داعمةٍ للتّغيير
شهدت وظيفة التفتيش التربوي في العقود الأخيرة تحوّلاتٍ عميقةً علىٰ مستوىٰ المفهوم والممارسة، وذلك في سياق السَّعي إلىٰ إصلاحِ المنظوماتِ التَّعليميّةِ، والانتقالِ بها من نموذجٍ تقَنيٍّ تقويميٍّ إلىٰ نموذجٍ تعلُّميٍّ تطويريٍّ.
فالأدبيّاتُ التربويّةُ المعاصرةُ تُجمِع علىٰ أنّ مهنةَ التفتيش التربوي أصبحت اليومَ من بينِ الرّوافِعِ الأساسيّةِ لدعمِ الجودةِ، وتمكينِ الفاعلينَ التَّربويّينَ، وتحقيقِ الإنصافِ والتّجديدِ المهنيّ، شريطةَ أن يُعادَ بناؤُها علىٰ أُسسٍ وظيفيّةٍ حديثةٍ، وتُمارَسَ ضمنَ منطقِ التّعاونِ والتّعلُّمِ المهنيِّ المُشترَك، وفيما يلي عرضٌ لأهمِّ التحوُّلات التي تنادي بها الأدبيات الحديثة في مجال التفتيش التربوي، مع الإحالة علىٰ أفضل الممارسات -في حدود ما اطَّلعتُ عليه- التي جسَّدت تلكم التحوُّلات المرغوبة:
أوَّلا: من الرّقيبِ إلىٰ المرافقِ التربويّ
لم يَعُد المفتّشُ في النّماذجِ التعليميّةِ المتقدّمةِ يُمارسُ مهامَّه من موقعِ الرّصدِ الخارجيّ، بل أصبح فاعلًا ميدانيًّا يُرافقُ الأساتذةَ، يُحفِّزُهم، ويُوفِّرُ لهم سُبلَ التّطويرِ المهنيّ. ويظهرُ هذا التّحوُّلُ جليًّا في تجربةِ زيمبابوي، التي طوّرت نموذجَ “الإشرافِ السّريريّ”، وباختصار فإنَّ هذا النَّموذج يجعل المفتشَّ يُواكِبُ المُدرّسَ داخلَ الصفّ، ويُوفِّرُ له تغذيةً راجعةً فوريّةً، مبنيّةً على الثّقةِ والتّشخيصِ، لا علىٰ التّوبيخِ أو التّقويمِ العِقابيّ.
ثانيًا: من التّركيزُ علىٰ شكليّاتِ الإنجاز إلىٰ التركيز علىٰ أثَرِ التّعلُّماتِ
تدعو هذه الأدبيّاتُ إلىٰ أن ينصبَّ التفتيش التربوي علىٰ نتائجِ التّعلُّمِ، وتحليلِ الصّعوباتِ، ودعمِ التّحسينِ، لا على مراقبةِ الوثائقِ وتفقُّدِ الجداولِ. وفي هذا السّياقِ، تُقدِّمُ تجربةُ إنجلترا نموذجًا متقدِّمًا في التّفتيشِ التّحسينيّ، حيث تهدف زياراتُ المُفتّشين إلىٰ تزويدِ المدرسةِ بتقريرٍ شاملٍ عن مكامنِ القوّةِ والضّعفِ، مدعومًا بتوصياتٍ إجرائيّةٍ ملموسةٍ لتحسينِ جودةِ التعليمِ.
ثالثًا: من الاقتصار علىٰ التّكوينِ المُستمرِّ إلىٰ تحقيق التّعلُّمِ الجماعيّ
تذهبُ الأدبيّاتُ الحديثةُ إلىٰ اعتبارِ التّفتيشِ أداةً مُندمجةً في منظومةِ التّكوينِ، عبر تصميمِ برامجَ مهنيّةٍ متدرّجةٍ، وتمكينِ الفاعلين من التّعلُّمِ المُشترَك. وقد بلورت فنلندا نموذجًا إبداعيًّا لهذا التّصوّرِ من خلال شبكة Lighthouse، حيث تشتغلُ المدارسُ كنقاطِ إشعاعٍ مهنيٍّ، تُنظِّمُ ورشاتٍ، وملاحظاتٍ مُتبادَلةً، وفُرَصًا للتّكوينِ من داخلِ المؤسّساتِ، بتنسيقٍ مع فِرَقِ التّفتيشِ والبحثِ التربويّ.
رابعًا: من الإجراء الافتحاصي الإداري إلىٰ منطقِ التّعاقدِ والمسؤوليّةِ المهنيّة
إنّ من أبرزِ ما تُؤكِّده المقارباتُ الحديثةُ: ضرورةُ تمتيعِ المفتّشِ باستقلاليّةٍ وظيفيّةٍ من جهةٍ، وربطِ أدائهِ بنتائجَ ملموسةٍ من جهةٍ أخرى، أي ضمنَ منطقِ التّعاقدِ القائمِ على الكفايةِ والنّجاعةِ. وقد تجسَّد هذا الطّرحُ في نموذجِ ماليزيا، حيث أُدمِج التّفتيشُ ضمن منظومةِ ضمانِ الجودةِ، وأُسنِدَ إليه دورٌ محوريٌّ في تتبُّعِ الأداءِ التَّعليميّ، مع تحميلهِ مسؤوليّةَ التّوجيهِ والتّحسينِ وفقَ معاييرَ وطنيّةٍ واضحةٍ.
خامسًا: من التكوين الأساس للمفتش إلىٰ لتّكوينِ المستمر وتحديث وتطوير أدواتِ التّفتيش
تُشدِّدُ مُعظمُ التّقاريرِ الدوليّةِ على أنّ مهنةَ التفتيش التربوي لا يمكن أن تنهضَ بدورِها دونَ إصلاحٍ جوهريٍّ لمنظومةِ التّكوينِ، سواء في مستواهُ الأساسِ أو المستمرِّ، وفي هذا السّياقِ، نجدُ مثالَ تركيا، حيث خلُصت مراجعاتُ السّياساتِ إلى أنّ تطوّرَ التّفتيشِ يقتضي تأهيلًا معمَّقًا للمفتّشِ في ميادينَ القيادةِ البيداغوجيّةِ، والتّقويمِ التّحليليّ، والتّخطيطِ التّكوينيّ، والتّواصُلِ المهنيِّ البنّاء. مع العمل المستمر علىٰ استئناف التكوين داخل وخارج الوطن، وبناء أدوات تفتيش أكثر تطوُّرًا.
وهكذا؛ تُظهِرُ هذه النّماذجُ والتوجّهاتُ أنّ وظيفةَ التّفتيشِ التربويِّ، كما تُعيدُ الأدبيّاتُ التربويّةُ الحديثةُ تصوّرَها، لم تَعُد أداةَ ضبطٍ أو مراقبةٍ، بل غدت عنصرًا حيويًّا في ديناميّةِ التّعلُّمِ، وتجويدِ التّدريسِ، ومرافقةِ التّغييرِ.
ومن شأنِ إدماجِ هذه الرّؤيةِ في السّياساتِ الوطنيّةِ، والاستفادةِ من التّجاربِ الرّائدةِ، أن يُمكِّنَ المدرسةَ المغربيّةَ من إحداثِ تحوُّلٍ نوعيٍّ في تَمثُّلِها لِلتّأطيرِ التربويّ، ويُحرِّرَ التّفتيشَ من البيروقراطيّةِ نحوَ الرّيادةِ التربويّةِ.
التفتيش التربوي في التربية الإسلاميّة: بين التّهميش والتطلعِ إلىٰ الإنصافِ
إنّ التطرّق إلىٰ المحاور السَّابقة لم يكن مجرّد استعراضٍ نظريٍّ لمفاهيم حول التفتيش التربوي ومهامه وتحولاته، بقدر ما كان محاولةً لإعادة ضبط بوصلة النِّقاش حول واقع مهنةٍ باتت تتقاطع حولها رهانات الإصلاح التَّربوي من جهة، وتحديات التَّنزيل من جهةٍ أخرىٰ. وقد أبان التَّحليل الذي قدَّمناه عن تعدّد الإشكالات البنيويّة والوظيفيّة التي تُقيّد هذا المجال.
وفي هذا الإطار، فإنَّ مادة التّربية الإسلاميّة، وإن كانت تنفرد بخصوصيّةٍ قيميةٍ وتكوينيّةٍ داخل المنهاج، فإنَّها لا تخرج عن سِياق هذه التحديات العامة، وبالتالي؛ لا يُمكن عزلها عن منطق الإصلاح الشامل الذي ينبغي أن يشمل جميع المواد. غير أنّ المقلق في الحالة الرَّاهنة هو أنَّ هذه المادة، إلىٰ جانب ما تُعانيه من اختلالات علىٰ مستوىٰ التفتيش التربوي تشترك فيها مع باقي المواد، أُضيف إليها إشكالٌ آخر يتمثّل في التّهميش المؤسساتي المتكرّر، ممّا يُثير الحاجة إلىٰ مساءلة هذا التَّوجه، لا من منطلقٍ انحيازيّ، بل من منظور يراعي مبدأ العدالة التربوية والإنصاف التأطيريّ بين جميع التخصّصات.
وسنكتفي في هذا التَّفاعل بعرض بعض تجلِّيات حالةِ التَّهميشٍ لهذه المادة علىٰ مستوىٰ التفتيش التَّربويِّ:
خصاصٌ بنيويٌّ في عددِ المفتّشين
تعاني عددٌ من الأكاديميّاتِ والجهاتِ من غيابِ مفتّشين لمادّةِ التّربية الإسلاميّة، أو من خصاصٍ حادٍّ لا يسمح بتغطيةٍ تأطيريّةٍ منتظمةٍ للمؤسّسات، وهذا الواقعُ لا يُعزى فقط إلىٰ التّوزيع الجغرافيّ كما قد يُصوِّره البعض، بل يُعزىٰ أيضًا إلىٰ محدوديّة التّكوينِ الأساسيّ وقلّةِ المناصبِ المفتوحةِ للمادّة في مبارياتِ ولوجِ مركزِ التّفتيش.
إقصاءٌ متكرّرٌ من مبارياتِ التّفتيش
تُشيرُ المعطياتُ الرّسميّةُ إلى غيابِ تخصّصِ التّربية الإسلاميّة في عددٍ من مبارياتِ التّفتيش (تكرَّر هذا في السنتين الأخيرتين)، وآخرها إعلانُ أبريل 2025، فهذا إقصاءٌ يُثيرُ الاستغرابَ حقيقةً، خصوصا في ظلّ الحاجةِ الميدانيّةِ المُلحّةِ، وارتفاعِ عددِ المُدرّسينَ الّذين لا يحظون بأيّ تأطيرٍ فعليٍّ.
ضُعفُ التّكوينِ المستمرّ والدّعمِ البيداغوجيّ
يُعاني مفتّشو التّربية الإسلاميّة – سواء المشتغلون منهم فعليًّا أو المنتظرون – من محدوديّةٍ في فرصِ التّكوينِ المستمرّ، ومن غيابِ مرافقةٍ بيداغوجيّةٍ منسّقةٍ، تُسهِمُ في تجديدِ الكفاياتِ ومتابعةِ المستجدّاتِ.
تأثيراتٌ سلبيّةٌ على المادّةِ والمُدرّسينَ والمتعلّمين
ينعكس هذا التّهميشُ سَلبًا علىٰ أداءِ المادّةِ في المنهاجِ، وعلى وُضوحِ مكانتِها التّربويّة، وعلى أداءِ مُدرّسيها، حيث يشعر كثيرٌ منهم بانفصالٍ عن التّوجيهِ المؤسّسيّ، كما يُؤدّي غيابُ التأطيرِ إلى غيابِ ديناميّةٍ بيداغوجيّةٍ داخل المادّة، ويجعلها عُرضةً للاجتهاداتِ الفرديّةِ غير المؤطّرة، ممّا يُؤثّر على صورةِ التّربية الإسلاميّةِ في وعيِ المتعلّمينَ والمجتمعِ.
إنّ حالةَ التّربية الإسلاميّة تمثّل نموذجًا ملموسًا لاختلال العدالة التّخصّصيّة في التأطير التّربويّ، وتُشير إلى فجوةٍ قائمةٍ بين الخطابِ الإصلاحيّ وممارساتِ التّنزيلِ الإداريّ، والحديثُ عن إصلاحِ التّفتيشِ لا يَستقيمُ دون إنصافِ جميعِ الموادّ، خاصّةً تلك الّتي تُشكّلُ ضميرَ المدرسةِ، وتُسهمُ في تحصينِ المتعلّمينَ أخلاقيًّا وقيميًّا.
النتائجُ والتّوصياتُ
أولًا: النتائج
- تُبيِّن المعطياتُ التي قارَبها هذا المقال أنّ مهنةَ التفتيش التربوي تحتلُّ موقعًا مركزيًّا في المشروع الإصلاحيّ للمنظومةِ التربويّة، غير أنّها ما تزال تعاني من اختلالاتٍ بنيويّةٍ وتنظيميّةٍ ووظيفيّةٍ، تُقيِّد أثرَها في تجويد الأداء التربويّ.
- يُجسّد التصوّرُ الذي تُقدّمه الرؤية الاستراتيجية ووثيقة المجلس الأعلى (2009) محاولةً واضحةً لإعادة بناء وظيفة التّفتيش على أسُسٍ جديدةٍ تُزاوج بين التّقويم والمصاحبة، وبين الدعم والقيادة، في أفق تجاوز المنظور التّقنيّ الضيّق.
- تُظهر الأدبيّات التربويّة المقارنة أنّ الأنظمة التعليمية المتقدّمة تتّجه نحو مهننة التفتيش، وتحريره من الوظائف الإجرائية الرتيبة، وتكريسه كرافعةٍ لتطوير التّعليم ودعم الفاعلين وتحقيق الجودة.
- تُجسّد وضعيّةُ مفتّشي التّربية الإسلاميّة نموذجًا دالًّا على غيابِ الإنصاف التخصّصيّ في السياسات التأطيريّة، من خلال محدودية التكوين، وندرة المناصب، وغياب التقدير المؤسّسيّ لمكانة المادّة ضمن البنية البيداغوجية للمدرسة المغربية.
ثانيًا: التوصيات
- تسريع ورش إصلاح وظيفة التفتيش التربوي، من خلال تفعيل مخرجات الوثائق الاستراتيجية، وملاءمة التنظيم الإداري والمهني لجهاز التفتيش مع التصوّر الجديد القائم على المصاحبة والتّكوين والتّقويم التكويني.
- إرساء مرجعيّة وطنيّة للكفايات المهنية الخاصّة بالمفتّشين، تُمكِّن من تحديد المهام والوظائف بدقة، وترسي آليات التّقويم والمساءلة المهنية، وتدعم التكوين الأساس والمستمر.
- تعزيز استقلالية المفتّش التربويّ داخل منطق الحوكمة التربوية التعاقدية، بما يضمن له هامشًا مهنيًّا للقرار التربوي، ويُمكّنه من المساهمة الفعلية في قيادة مشاريع الإصلاح وتتبّعها.
- ضمان العدالة التأطيرية عبر تخطيطٍ استراتيجي لتوزيع الموارد البشرية المؤطرة، يُراعي الحاجات الحقيقية للمؤسسات التعليمية، ويُعالج الفوارق الجغرافية والاختصاصية، خصوصًا في التخصصات التي تعرف تهميشًا مزمنًا.
- إنصاف مادة التربية الإسلامية في برامج التكوين والتأطير، وفي مباريات الولوج، وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص بين التخصّصات، ويعكس مكانة المادة في بناء شخصية المتعلم وقيم المدرسة.
- الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في إصلاح التفتيش التربوي، خصوصًا في ما يتعلق بالمصاحبة الميدانية، والتفتيش المبني على النتائج، وديناميات التكوين الجماعي، وربط التفتيش بمؤشرات التحسين المدرسي